سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!
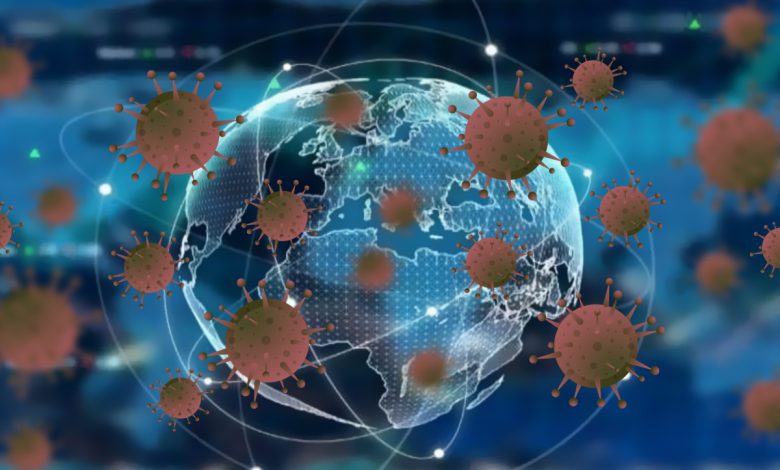
فيروس كورونا.. تراجع العولمة وتغير توازنات القوى الاقتصادية
السفير عمرو حلمي
من بين كمٍّ هائلٍ من المقالات والأوراق البحثية التي صدرت إثر تفجر أزمة انتشار فيروس كورونا، وإجماعها على أن العالم مقبل على أن يشهد تراجعًا عن العولمة؛ فإنه من الأهمية توضيح أن العولمة أصبحت سمة من سمات عالمنا المعاصر التي لا يمكن التخلي عنها أو التضحية بها، لذا فكل ما يمكننا توقعه يكمن في أن التركيز سينصب على مجرد محاولة الحد من بعض آثارها السلبية، خاصة فيما يتصل بسلاسل الإنتاج والعرض الممتدة عبر مختلف قارات العالم، مع إدراك أكثر عمقًا لمقتضيات الحفاظ على السيادة الاقتصادية والمصالح الوطنية والأمن القومي. فمن الملاحظ أن الاستثمارات الأجنبية التي انهمرت على الصين كانت في بادئ الأمر تهدف إلى الاستفادة من المزايا النسبية التي تتصل بانخفاض تكاليف العمالة، ثم تغيرت مقاصدها بالتركيز على محاولة الاستفادة من المزايا التنافسية وهي تلك التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية الهائلة للسوق المحلية، وكفاءة وانضباط العمالة، وارتفاع المستوى العلمي للفنيين، وقد تم ذلك من قبل العديد من الدول والشركات العالمية الكبرى دون الالتفات إلى الاعتبارات المتصلة بسجل الصين في انتهاكات حقوق الإنسان، وحرية التعبير، ومتطلبات حماية الأقليات، وحتى لمعايير الحفاظ على البيئة وحقوق العمالة أو المساواة بين الجنسين التي تم التضحية بها والتغاضي عنها في إطار السعي إلى تعظيم الأرباح.
وقد سمح تداخل الصين في العديد من سلاسل الإنتاج والعرض بتحولها تدريجيًّا إلى أن أصبحت أكبر قاعدة للتصنيع على مستوى العالم، واتضح للعديد من الدوائر الاقتصادية الغربية أن الصين باتت تمتلك التأثير في قدرة الشركات العالمية على التحكم في إنتاج العديد من المنتجات في قطاعات بالغة الأهمية، كالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ووسائل النقل، والمواصلات، والصناعات الصيدلانية والطبية، فضلًا عن صناعة الأثاث ومستلزمات المنازل والمنسوجات والملابس الجاهزة، بعد أن تم ترحيل العديد من الصناعات وبعض مكوناتها الرئيسية إليها، وأصبح من الصعوبة حاليًّا أن نجد في الأسواق الدولية العديد من المنتجات دون اتصالها بدرجة مباشرة أو غير مباشرة بالصين، سواء كموطن لإنتاجها بالكامل أو لإنتاج جانب هام من مكوناتها. وقد وجدت شركتا نيسان وتويوتا أن مصانعهما في اليابان لا يمكن أن تستمر في الإنتاج بالمعدلات المطلوبة دون حصولهما على المكونات الرئيسية لصناعة السيارات التي سبق للشركتين إقامة مشروعات استثمارية بشأنهما في الصين. كما أثبتت أزمة كورونا أن الصين بفضل الاستثمارات الغربية أصبحت تنتج نصف الاحتياجات العالمية من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتحكم مع الهند في نسبة هائلة من المنتجات الصيدلانية، بما جعل كفاءة العديد من الدول الغربية في التعامل مع تداعيات كورونا تتوقف على الإمدادات من المستلزمات الوقائية والطبية التي يمكنهم التحصل عليها من الصين.
ونظرًا لتصاعد النزاعات التجارية بين العديد من القوى الاقتصادية والصين نتيجة لبعض ممارساتها المخالفة لمبادئ حرية التجارة التي تقوم على الإغراق، وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية، وتخفيض قيمة العملة الوطنية من أجل زيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية، فضلًا عن العديد من الإجراءات المقيدة للأعمال، والتي تتزامن مع تزايد العراقيل أمام رغبة العديد من الدول في التوصل إلى معالجة للفائض التجاري الهائل الذي تحققه الصين معها؛ فإن ذلك يجعلنا نتوقع أنه إذا كانت هناك انعكاسات حقيقية لأزمة كورونا على العولمة، فإن جانبًا كبيرًا منها سيتعلق بإعادة النظر في مشاركة الصين المتزايدة في سلاسل الإنتاج والعرض وفي استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وحتى برامج نقل التكنولوجيا إليها، أو السماح لها بمواصلة الاستحواذ على المعارف الإنتاجية المتطورة بنفس المعدلات التي اتسمت بها في السابق سياسة العديد من الدول والدوائر الاقتصادية الغربية في تعاملاتها مع الصين، خاصة وأن الأمر يمكن أن يدفعها إلى التحلي بنظرة استراتيجية أكثر عمقًا عند النظر في توطين العديد من المشروعات الإنتاجية بها، والتي حولتها إلى واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.
فإذا كانت الصين قد تخطت مكانة اليابان كثاني أكبر الدول المصدّرة في العالم، فإن نسبة كبيرة من صادرات الصين تتعلق بصادرات المشروعات الاستثمارية الأجنبية المتوطنة بها وليس من جراء تصدير منتجات بتكنولوجيا صينية خالصة، وهو ما ينطبق -على سبيل المثال- على منتجات شركة “آبل” الأمريكية ومنتجات شركة “هوندا اليابانية” التي يتم تصنيعها في الصين، وتدخل في بنود صادراتها على الرغم من كونها منتجات تم مجرد تصنيعها في الصين بتكنولوجيات أجنبية كاملة. وفي هذا الصدد فإنه لا يمكننا تقييم التطور الهائل الذي شهدته مكانة الصين كإحدى القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم دون الالتفات إلى حقيقة تأثير الاستثمارات الأجنبية بها، حيث تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى في قيمة الاستثمارات الأجنبية في الصين، حيث وصلت قيمتها التراكمية حتى ٢٠١٨ إلى ١٧٢ مليار دولار، تليها الاستثمارات البريطانية بقيمة تقدر بـ٧٢ مليار دولار، ثم السويسرية بقيمة ٦٠ مليار دولار، فالكندية بقيمة ٥٠ مليار دولار، ثم الروسية بقيمة ٣٨ مليار دولار. ونجحت الصين في جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ١٣٨ مليار دولار في عام ٢٠١٨ وحده لتحتل المرتبة الثانية عالميًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًّا على مكانتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بما مكّنها من أن تتبوأ المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول المصدرة عالميًّا. فقصة الصعود السلمي للصين منذ عام ١٩٧٩، والنجاح الهائل الذي حققته في تطوير مكانتها الدولية، وفي القضاء على الفقر، وكذلك في تكوين احتياطي هائل من النقد الأجنبي؛ لا يجب النظر إليه بمعزل عن تأثيرات التدفقات الهائلة للاستثمارات الأجنبية إليها والتي لا يمكن تجاهلها في إطار الدراسة الموضوعية لتحولها إلى ثاني أكبر القوى الاقتصادية في العالم.
ومع كل الآراء التي تُرجِّح أن العالم ما بعد تحدي كورونا لن يكون كما قبله، فإن ذلك -في حد ذاته- يعزز من احتمالات أن نشهد تحولات جذرية في موازين القوى الاقتصادية بأهداف جديدة للعولمة، وبمسارات مغايرة لسلاسل الإنتاج والعرض العالمية، بعد أن أدركت العديد من الدوائر السياسية والاقتصادية الغربية أن الوقت قد حان لاتخاذ كل ما من شأنه أن يساعد في إعادة بناء السيادة الوطنية من خلال استرجاع عدد من الصناعات التي سبق توطينها في الصين، وإعادتها إلى دولها الأصلية، بما يوحي بأن النظرة الاستراتيجية واعتبارات الأمن القومي ستطغى أهميتها على الاعتبارات ذات الصلة بالمزايا النسبية أو التنافسية وبتحقيق الربح، خاصة بعد أن اتضح للغرب أنه ربما قد يكون قد أسهم -دون أن يدرك- في تحول دولة آسيوية إلى قوة عظمى اقتصادية باتت تتنافس معه، وأصبحت تؤثر في توازنات القوى بصورة مخالفة لمصالحه ولكفاءة تناوله للتحديات التي تواجهه.