سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!
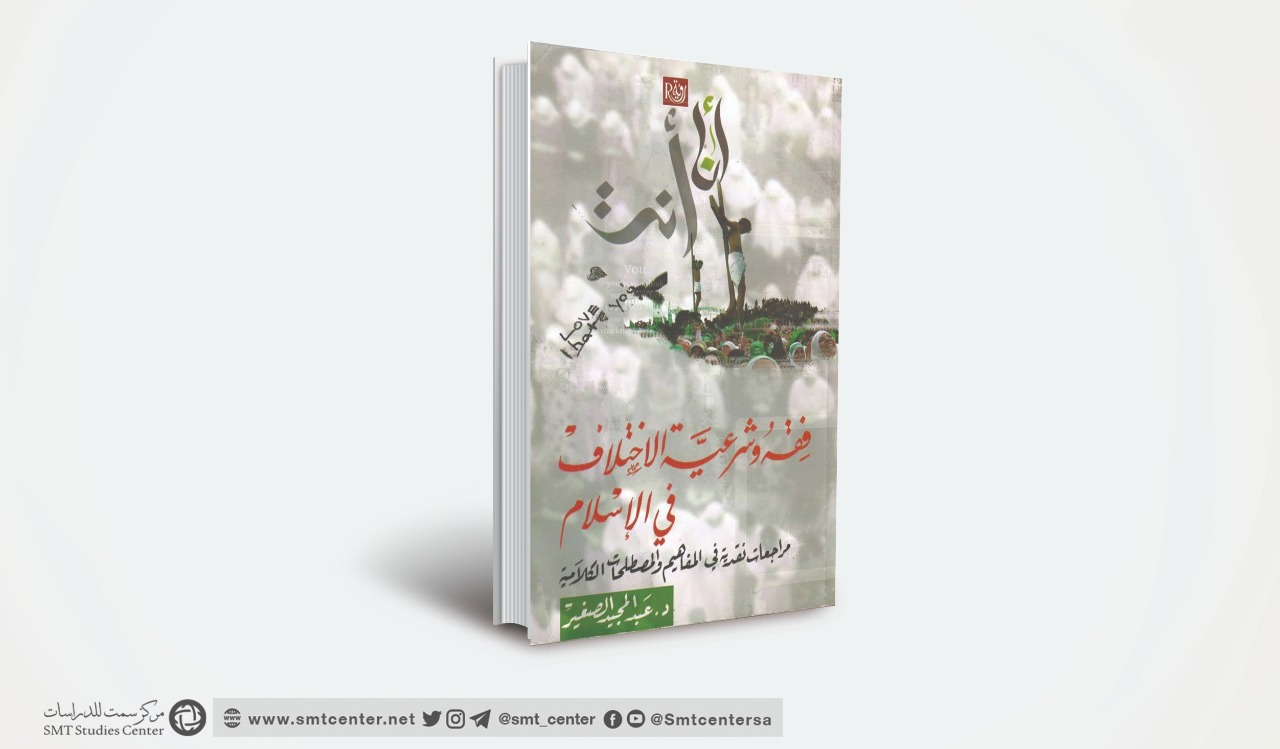
فقه وشرعية الاختلاف في الإسلام
إن الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، قد أظهرت للجميع أن القيم الدينية والحضارية والإنسانية عامة قد صارت من جديد حاضرة في أحداث العصر، مؤثرة مع عوامل أخرى في رسم مستقبل الإنسانية ومستقبل العلاقة بين الإسلام والغرب خاصة، وذلك سبب وجيه يدفعنا لتجديد النظر في علم الكلام تجديدًا نميز فيه بين الثابت والمتغير والمجتمع حوله والشاذ، ونعلي فيه من شأن الرؤى الفلسفية ومناهج البحث وأخلاقيات الحوار والمناظرة، بما يساعد على تدبير الاختلاف وترشيده وتوجيهه، تحقيقًا لمقاصد شرعية كلية، وطلبًا لمصالح إنسانية مشروعة كفيلة بجعل هذا الاختلاف سبيلاً للتعارف وداعيًا للتواصل مع الآخرين (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
في هذا الإطار يعرض الباحث عبدالمجيد الصغير، وتحت عنوان (فقه وشرعية الاختلاف في الإسلام مراجعات نقدية في المفاهيم والمصطلحات الكلامية) إشكالية الاختلاف وشرعيته عبر التاريخ الإسلامي.
ينطلق الكاتب من أهمية النص ودوره، وموقعه في التاريخ الفلسفي، إذ يدرك المتمرس للعلوم الإنسانية تلك المنزلة الخاصة التي تحتلها “النصوص” في تلك العلوم عامة، وفي تاريخ الفلسفة على وجه الخصوص، ما دام النص بطبيعته قابلاً في هذه العلوم للتحول إلى “حدث يؤرخ له وبه، وما دام هذا النص قد صار، بفضل ذلك، يمثل “الشهادة” الأولى، وربَّما الشهادة الوحيدة التي تحيلنا إلى الممارسة الفلسفية نصًا مكتوبًا بالضرورة، و”وثيقة” يمكن الاحتكام إليها، و”حدثًا” قابلاً في نفس الوقت للتأريخ والتقويم له، سواء في نفسه أو في ضوء علاقاته الممكنة بنصوص أو علوم أخرى، إنسانية وطبيعية. ثم يأتي القارئ المؤول ليشكل نقطة التقاء وتفاعل بين همومه الآنية وتطلعاته المستقبلية وبين المحمولات المعرفية الممكنة للنص المتعامل معه.
فالنص الفلسفي إذًا شأنه في ذلك شأن أغلب نصوص العلوم الإنسانية، مهيأ بطبيعته لأن يتحول إلى نص يمارس “سلطة” على قرائه؛ فلطالما لعبت نصوص عديدة في تاريخ الفكر الإنساني دور السلطة الثابتة والمرجع الأساس والمقياس المعتمد الذي يهرع إليه عند كل اختلاف في القراءة أو الفهم، بحيث يصبح ذلك النص سلطة فعلية وعنصرًا حاضرًا متفاعلاً مع التاريخ بكيفية مستمرة وبأشكال متباينة، بل ومتناقضة.
هنا يذهب الكاتب إلى أن كل نص تأسيسي يحمل في ذاته بحكم قيمته التأسيسية، وبحكم تدشينه تقليدًا أو سنة أو حركة أو اتجاهًا جديدًا، قابلية التحول إلى نص مرجعي، بل إلى نص “مقدس”، مهما كان مصدره الذي ينسب إليه، إذ المعتبر في القداسة هو القيمة التأسيسية التدشينية أكثر مما هو في المصدر المنسوب إليه. وفي هذا تتساوى نصوص عديدة في معانقة صفة القداسة، وإن لم يكن عن سائر أتباعها، فهي كذلك عند العديد منهم. وفي هذا يورد الكاتب العديد منها:نصوص التوراة، وبعض نصوص أفلاطون، ونصوص أرسطو، سواء في توظيفها اليونانية أو الهيلينية أو المسيحية أو الإسلامية أو الأوروبية النهضوية، ونصوص الأناجيل، والقرآن، وصحيح الحديث، والنصوص التأسيسية للماركسية، ومن خلالها بعض نصوص هيجل الرئيسية. ولعل التمييز بين الأرثوذكسية وبين القراءة المفتوحة لهذه النصوص، ما يعكس فعلاً مشكلة القداسة القريبة من كل نص قدّر له أن يؤدي دورًا ما في حياة البشر. غير أن تلك القداسة التي تعني في سياق هذا المُشكِل ما كان محرمًا لا يجوز مسه، وفي الوقت نفسه الذي يحتفظ فيه ذلك النص بسلطته المؤثرة، تصبح تلك القداسة ذات دور سلبي مقارنة مع شروط الفاعلية التاريخية (العقلانية والتحرر) كلما كان ذلك النص المهيمن، وهو “النموذج الأمثل”، نصًا ذريًا تجزيئيًا محددًا لجميع الأشكال والأنماط الممكنة للتفكير والممارسة والفاعلية الأساسية لأن بذلك يكون قد حكم على هذه الفاعلية بالجمود والتوقف.
الحاجة لمراجعة كتابة تاريخ الفكر الإسلامي
يطرح الكاتب ضرورة القيام بمراجعة شاملة في عملية كتابة تاريخ الفكر الإسلامي، على أن تتم هذه المراجعة التاريخية أيضًا في ضوء التحليل اللغوي والدراسات المنطقية واللسانية المعاصرة ومراعاة مقاصد الخطاب، وذلك بما يلائم خصوم المادة المتعامل معها والمتمثلة في تلك النصوص التي تمثل الشهادات الوحيدة عن الحديث الفكري المراد التأريخ له، حيث تتأكد ضرورة عملية إعادة كتابة تاريخ المتن الكلامي، كيفما كان انتماؤه، في ضوء تحليل البنية اللغوية للنص، وكذا تحليل الظرفية التي تظل في الغالب مغيبة وإلى اليوم عن أغلب الذين يتصدون لتأريخ وتقييم النص الكلامي. ولعل في تلك الضرورة ما يوضح أهمية القيام بمقايسة بين تاريخ الكلام وتاريخ اللغة والأدب، أو بينه وبين تاريخ علم الأصول وتاريخ المجتمع ككل، وبين تاريخ الفكر وتاريخ المنتج لذلك الفكر. لا بدَّ إذًا من إعادة تأريخ الفكر الإسلامي ومراجعته بموازاة مع تاريخ المجتمع الذي عرفه ونشأ فيه. وإن من جملة أنواع القصور البادي في التأريخ لأهم علوم الإسلام، ضعف تلك الوشائج بين نشأة العلم أو إنتاجه وبين مقتضيات تلك النشأة ومقاصدها العامة، رغم أن الفكر الإسلامي كان مهيأ أكثر للاعتناء بهذا الجانب نظرًا لانشغال مفكريه وفقهائه بما تعم به البلوى في الحياة المعيشية.
هنا ينتقل الكاتب إلى إشكالية مفهوم السببية الذي حاول المفكر محمد عابد الجابري توظيفه ليتخذ منه شاهدًا على القطيعة التي جعل منها سدًا يمنع كل تواصل أو توافق بين مفكري الإسلام في المشرق ومفكريه في الغرب الإسلامي، حيث اتخذ من ابن سينا والغزالي خاصة النموذجين المشرقيين المختلفين بنية عن نماذج الغرب الإسلامي المتمثلة بالتحديد في ابن حزم وابن رشد والشاطبي وابن خلدون. فإذا كانت هناك إمكانية البحث عن هذه الإشكالية، نجد أنه بالإمكان الكشف عن تهافت مفهوم القطيعة كما أراد صاحبها أن يعممها بين مفكري المشرق والمغرب، إذ يحرص الكاتب على ألا يختتم بحثه حتى يقدم الدليل على وحدة الرؤية المنهجية لمشكلة السببية ما بين ابن حزم وسائر المدرسة الأشعرية، وخاصة عند الغزالي. لقد كان ابن حزم أسبق من الغزالي في تقرير نفس تلك الرؤية كما سجلها الغزالي في (تهافت الفلاسفة)، وتنهض نصوص ابن حزم دليلاً على رفضه لتلك الرؤية الأرسطية كما سيعبر عنها ابن رشد. وهو ما يعدُّ دليلاً آخر على أن محمد عابد الجابري، كان يلجأ مرارًا وتكرارًا إلى أسلوب الحذف والإبعاد والإهمال لنصوص “نماذجه” من المفكرين إذا ما رأى فيها ما يعارض “تأويله” وقراءته لتراثه. ولا أدل على ذلك فيما يعارض “تأويله” وقراءته لتراثهم. ولا أدل على ذلك من هذه النصوص الحزمية التي يمثل لها الكاتب، والتي تقوم شاهدًا على التواصل والتوافق بين ابن حزب والغزالي مثلما تقوم شاهدًا على صعوبة تقريب ابن حزم إلى ابن رشد الفيلسوف في المشكل المطروح. فبخصوص مفهوم الضرورة والإمكان اللذين لجأ إليهما الغزالي وأثار عليه نقدًا رشديًا، يؤكد ابن حزم هذين المفهومين معممًا إياهما على القضايا التشريعية والطبيعية، ومنطلقًا من تحديده لوظيفة العقل في المجالين معًا.
الكتاب قدَّم معالم من شرعية الاختلاف في التجربة الإسلامية، وقد كان أبرز دلالاتها ذلك الإجماع الكلامي حول رفض التقليد في باب العقيدة. ومن حسن حظ التجربة الإسلامية خلوها من مثل تلك “المجامع العقدية” التي امتلأ بها تاريخ المسيحية، تلك المجامع التي ربطت فرض العقيدة بقوة السلطة السياسية، وجعلت نوع تلك العقيدة مرهونًا بعدد “المصوتين” على شرعيتها والحاضرين للتداول في فرضها.
وبالتالي، يميز الكاتب بين العقيدة الإسلامية و”الاجتهاد الكلامي” في العقيدة، تمامًا كما تمَّ التمييز بين المقاصد الشرعية الكلية القطعية، وبين المذاهب الفقهية القائمة على الاجتهاد والأحكام الظنية. وكما أنه من الخطأ اعتبار مذهب فقهي معين وحده المعبر عن جوهر الشريعة ومراد الشارع في باب المعاملات، فمن الخطأ كذلك، وبشكل أقوى اعتبار كل تأويل كلامي معين، دون غيره، الرأي المطابق للعقيدة الإسلامية. ذلك أن معيار الانتساب إلى العقيدة الإسلامية قائم أساسًا على الإقرار بالتوحيد المطلق والتنزيه الخالص للذات الإلهية، والإقرار بالنبوة وبأن محمدًا رسول الله، وخاتم سلسلة من أنبيائه ورسله، والإيمان بيوم الحساب، واعتبار القرآن مصدرًا للقيم ومصدرًا للتشريع، واتخاذ السنة دليلاً مرشدًا لتنزيل تلك القيم وذلك التشريع على أرض الواقع.
معلومات الكتاب
